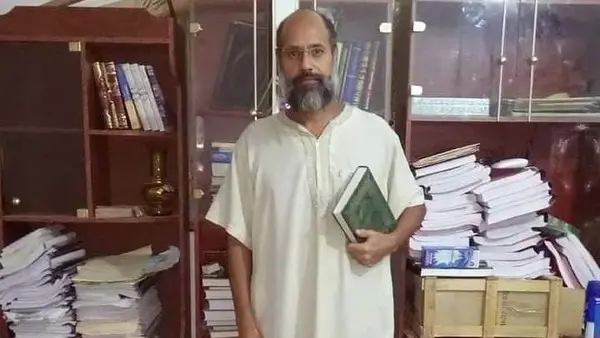كتب للشرق تريبيون - عادل محمود
لم تكن الصورة التي جرى تداولها قبل أيام لرجل وزوجته داخل المتحف المصري الكبير، يتجولان بزيهما الريفي التقليدي، مجرد لقطة عابرة التقطها هاتف محمول. كانت أقرب إلى لحظة اصطدام بين عالمين، صورة بسيطة الملامح، لكنها كشفت انفصاما طويلا عاشه المصريون بين جذورهم العميقة في الريف، وصورتهم التي يسعون إلى تقديمها في الفضاء العام.
دخل الرجل وزوجته إلى المتحف بثياب تحمل رائحة الأرض القديمة، وسط فضاء معماري فخم مصمم وفق أحدث المعايير العالمية. بدا المشهد صادما للبعض، ومريحا للبعض الآخر. لكنه في كل الأحوال لم يمر مرور الكرام. كشف عن معركة صامتة يجري إنكارها منذ سنوات، معركة تدور حول معنى الهوية، وحدود الذوق العام، وما إذا كان المتحف ـ الذي يفترض أنه يضم ذاكرة أجدادنا ـ ملكا لكل المصريين حقا، أم أنه تحول تدريجيا إلى ساحة مغلقة لا يدخلها سوى من تلتقي ملامحه مع المعايير غير المكتوبة للطبقة الوسطى.
هذه اللحظة القصيرة، التي لم تتجاوز ثواني أمام عدسة هاتف، تحولت إلى مرآة كبيرة أعادت طرح سؤال ظل مؤجلا طويلا: من الذي يملك حق الظهور في الفضاء الثقافي؟ ومن الذي يقرر ما هو "ملائم" أو "غير لائق"؟
ولماذا يجد أبناء الريف أنفسهم محل نقد أو سخرية حين يرتدون زيهم التقليدي خارج قراهم، بينما يصفق الجميع للتراث حين يبقى حبيس المسرح أو المتحف؟ يقدم المتحف في الخطاب الرسمي باعتباره فضاء مفتوحا للجميع. لكن قراءة أكثر عمقا للسياق الاجتماعي تكشف أن المتحف، في مصر كما في دول كثيرة، ظل ساحة ترسيم طبقي صامت. فالمتحف المصري الكبير، بتصميمه المعماري الضخم واسعار تذاكر الدخول المرتفعة ، وبالصورة الذهنية التي ترسخت حوله قبل افتتاحه، أصبح رمزا لمستوى اجتماعي معين، وإن لم يعلن ذلك صراحة.
في الثقافة المصرية المعاصرة، ارتبطت زيارة المتاحف بطبقة معينة. وغالبا ما يجري النظر إلى اللباس والسلوك واللغة باعتبارها عناصر تحدد مدى "الملاءمة" للوجود داخل هذه المساحة.
وقد وثق عدد من الباحثين في الأدبيات الاجتماعية المصرية هذا الميل، ومنهم الباحث الراحل الدكتور سيد عويس في دراساته عن "القيم الطبقية في المجتمع المصري"، حيث أشار إلى أن الفراغات الثقافية في المدن الكبرى تتحول بطبيعتها إلى ساحة فرز ضمني، حتى وإن رفعت شعار الانفتاح على الجميع.
وليس المصريون وحدهم من عاشوا هذا الأمر. فالمتاحف الأوروبية، منذ القرن الثامن عشر، كانت حكرا على النخبة. دخولها كان يحتاج إلى لباس محدد، وسلوك معين، ولهجة لا تنتمي إلى الطبقات الدنيا. ومع اتساع فكرة المتحف للجمهور في القرن التاسع عشر، بقي التمييز غير مكتوب لكنه حاضر بشدة.
وما يزال الجدل قائما حتى اليوم في فرنسا وبريطانيا حول "هوية رواد المتاحف" وكيفية التعامل مع الفئات الشعبية. الصورة التي التقطت داخل المتحف المصري الكبير لم تكن مجرد دخول لزوار بملابس ريفية، بل كانت اختراقا لهذه الحدود الصامتة.
وقد شعر البعض بالانزعاج لأن المشهد ذكرهم بأن المتحف ليس ملكا للطبقة لأبناء المدينة وحدها، وأن الماضي الذي يعرضه المكان هو تراث هؤلاء الفلاحين أنفسهم، وربما أكثر مما هو تراث أبناء المدن. في مصر، يزداد المشهد تعقيدا بفعل التاريخ.
فالمتحف المصري منذ نشأته على يد الخبير الفرنسي مارييت باشا في القرن التاسع عشر، كان مبنيا على النموذج الأوروبي للمتاحف. ورغم أن القطع المعروضة مصرية خالصة، فإن فلسفة العرض، وطريقة الوصف، ونظام الحركة الداخلية كلها تحمل أثر المدرسة الغربية في علوم الآثار والمتاحف.
جاء المتحف المصري الكبير ليقدم نفسه كنقلة نوعية، لكنه ظل تابعا لنمط عالمي يرى أن المتحف مكان "راق" و"حديث" و"مهيب". هذه الصورة تغري السائح وترضي النخبة، لكنها كثيرا ما تُشعر أبناء المناطق الشعبية بأن هذا المكان ليس لهم تمامًا.
وهنا تظهر المفارقة. فالمتحف الذي يضم آثار الفراعنة، أجداد الفلاح الحالي، يفتح أبوابه أمام الجميع، لكنه في لاوعي المجتمع يصبح مكانًا لأبناء الطبقة الوسطى العليا، بينما يشعر أبناء الريف بأن وجودهم فيه مشروط بارتداء ما هو "عصري" وما ينسجم مع الذوق المهيمن. هنا تظهر واحدة من أكبر الإشكاليات: نستعيد تراث أجدادنا وفق معايير غربية، ثم نلوم أبناء هذا التراث أنفسهم لأن شكلهم أو لباسهم لا يناسب الفضاء الجديد الذي أنشأناه.
لم يكن الجدل الذي تفجر بسبب الصورة مجرد نقاش حول اللباس، بل كان نافذة كشفت ما هو أعمق. كثير من المنتقدين ينحدرون أصلا من الريف أو من أحياء شعبية، وقد أظهرت كتابات علم النفس الاجتماعي أن الفرد الذي يحاول الارتقاء الطبقي يظل يحمل داخله شعورا دفينا بالنقص تجاه ماضيه.
وعندما يواجه صورة تذكره بجذوره التي يحاول الهرب منها، ينشط ما يسميه علماء النفس آلية "الإسقاط". فيرفض في الآخرين ما يريد نسيانه داخل نفسه، ويهاجم ما يذكره بصفحة من ماضيه لم يتصالح معها بعد. هذا التفسير ليس تنظيرا. فقد أكد أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة عين شمس في مقابلة صحفية عام 2024 أن هذا النوع من السخرية "ليس رفضا للزي الريفي، بل رفض للذات الأولى".
وأضاف أن المصري الذي صعد اجتماعيا "يخشى مواجهة جذوره فيركلها كلما ظهرت أمامه". وهكذا تتحول صورة عادية في متحف إلى معركة داخلية بين طبقات متعارضة داخل النفس نفسها. الأزمة هنا ليست أزمة ملابس. إنها أزمة تعريف بالذات. فهناك جزء من المجتمع يسعى بكل قوته للإندماج في نموذج غربي يرى فيه معيار التحضر.
يقابله جزء آخر ما زال يحمل في تفاصيله اليومية وعاداته ولهجته وملابسه جذور الريف والصعيد والنوبة والدلتا. والصورة وضعت النموذجين في الإطار نفسه، فاشتعل الصدام.
المفارقة في ردود الفعل أن المجتمع نفسه الذي يحتفي بالفنون الشعبية في الاحتفالات الرسمية، ويرى في التراث مادة للترويج السياحي، هو المجتمع ذاته الذي ينتقد حين يظهر هذا التراث في سياق الحياة اليومية. فالمشهد مقبول حين يكون على المسرح، و"غير لائق" حين يكون داخل المتحف. كأننا نقبل التراث فقط إذا كان محاصرا داخل إطار، تماما كما تعلق لوحة على جدار دون أن يسمح لها بأن تعيش بين الناس.
نشاهد في المهرجانات الدولية فرق الفن الشعبي وهي ترتدي الأزياء التقليدية بكل فخر. ونتباهى عالميا بالرقصات الفلكلورية والآلات القديمة المصنوعة يدويا. لكن حين يظهر الريفي بزيه الطبيعي في فضاء حديث يختفي هذا الفخر، ويتحول إلى نوع من الارتباك أو الاستهجان.
هذه الازدواجية لخصها تقرير صادر عن "المركز المصري للبحوث الاجتماعية" عام 2019، الذي أكد أن المجتمع المصري "يرحب بالتراث كمنتج سياحي، لا كهوية يومية حقيقية".
يظهر ذلك بوضوح في الإعلام. فالشخصيات الريفية كثيرا ما تقدم بصورة نمطية، إما ساذجة أو عنيفة أو جاهلة. أما حين يستخدم التراث كجزء من ديكور أو مناسبة قومية، يصبح مادة احتفاء.
هذه العلاقة المرتبكة بالتراث تكشف أزمة أعمق تتعلق بالشعور بعدم التوازن بين الماضي والحاضر. لكي نفهم حساسية المشهد، لا بد من العودة إلى تاريخ الملبس نفسه في مصر. فالثياب لم تكن في أي عصر مجرد اختيار شخصي، بل كانت وثيقة سلطة تحدد الطبقة والانتماء. في العصر الفرعوني، كان الكتان الأبيض الناعم امتيازا للنخبة، بينما ارتدى العمال والفلاحون أقمشة أكثر خشونة.
كانت الثياب تشير بوضوح إلى موقع الفرد في المجتمع. ومن يخالف هذا النظام يعد خارجا على التراتبية.
ومع دخول العرب ثم العثمانيين، تغيرت رموز السلطة. صارت الجلابية والعمامة والقفطان جزءا من معادلة اجتماعية جديدة. لكن ما بقي ثابتا هو أن لكل طبقة زيا محددا، ولكل زي حدودا لا يتجاوزها أحد. هذه الرمزية لم تختف مع الزمن، بل اتخذت أشكالا مختلفة.
ثم جاء محمد علي بمشروع تحديث الدولة. فرض الزي الموحد على الجنود والموظفين والطلاب، واستبدل العمامة بالطربوش، والجلابية بالقفطان والبدلة شبه الأوروبية. كان الهدف الظاهر هو "التمدن"، لكن الهدف الأعمق كان صياغة مواطن جديد يتماهى مع الدولة الحديثة التي أراد بناءها.
ومن هنا أصبح الزي قرارا سياسيا لا مجرد مسألة ذوق. وخلال النصف الأول من القرن العشرين، أصبحت البدلة علامة على "المدنية" والتقدم. بينما دفع الزي الريفي إلى مربع "التخلف". وثقت إحدى تعليمات وزارة المعارف في ثلاثينيات القرن الماضي أن "المظهر اللائق للمدرس هو البدلة والطربوش".
وهو ما أدى عمليا إلى استبعاد أصحاب الزي التقليدي من المؤسسات التعليمية. حتى في الصور القديمة للمدارس الريفية، يظهر المعلم الذي يرتدي الجلباب واقفا في طرف الصورة، كأنه خارج الإطار المطلوب.
هذه التفاصيل الصغيرة صنعت مع الوقت ترميزا شديد القوة. فأصبح اللباس معيارا للحكم على المكانة الاجتماعية، ومعيارا للقبول أو الرفض في مؤسسات الدولة. شهدت مصر خلال النصف الثاني من القرن العشرين واحدة من أكبر موجات الهجرة الداخلية في تاريخها الحديث. ملايين انتقلوا من القرى إلى المدن، بحثا عن فرص تعليم أو عمل أو حياة مختلفة. لكن الهجرة لم تكن مجرد انتقال جغرافي. كانت انتقالا ثقافيا، حمل معه ثمنا لم يعلن عنه كثيرا.
ففي دراسة صادرة عن "المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية" عام 1981 بعنوان "الهجرة الداخلية وسلوك التكيف الحضري"، تبين أن أكثر من 70 في المئة من القادمين الجدد إلى القاهرة تخلوا عن الزي الريفي بعد ستة أشهر فقط من وصولهم.
لم يكن السبب اقتصاديا أو وظيفيا كما قد يتخيل البعض، بل كان "خوفا من الوصم الاجتماعي" كما وصفت الدراسة. ارتداء الجلباب في المواصلات العامة كان يكفي لإثارة التعليقات الساخرة أو النظرات المستعلية، ما جعل الكثيرين يعتبرون تغيير الزي شرطا من شروط دخول المدينة. هذه الضغوط لم تؤثر على الوافدين فحسب. بل أعادت تشكيل الريف نفسه.
فمع صعود الطبقة الوسطى في السبعينيات، وتزايد السفر إلى دول الخليج، أصبحت العلامات الأجنبية رمزا للتقدم والرفاهية. اختفت تدريجيا مظاهر الزينة الشعبية في الأفراح، وحل محلها "الفستان الغربي" و"البدلة الإيطالية".
حتى الأعراس الريفية التي كانت ساحات لاستعراض الأزياء التقليدية باتت تشبه حفلات المدينة. وكأن الحداثة لا تدخل البيوت إلا عبر الملابس المستوردة. هذا التحول لم يكن وليد التغيرات الاقتصادية وحدها، بل كان نتيجة شعور جمعي بأن الزي المحلي غير قادر على مواكبة العصر.
وهو ما عمق الفجوة بين الريف والمدينة، وبين الجذور والصورة الجديدة التي يسعى البعض إلى فرضها على المجتمع. المتحف المصري الكبير يمثل لحظة ذروة لهذا المسار التاريخي. فهو مشروع وطني ضخم، يبرز بصورة لامعة على المستوى المعماري والسياحي.
ولكن خلف واجهته المبهرة، يعيش المتحف مثل غيره من المؤسسات الثقافية تحت تأثير ما يمكن وصفه بـ"نظام الذوق الطبقي". حين دخل الرجل والمرأة بلباسهما الريفي، لم يقصدا تحدي المكان.
لكن وجودهما كشف فجأة ما يحاول البعض إخفاءه: أن هناك صورة ذهنية تفرض على زوار المتحف، صورة توحي بأن هذه المساحة تخص الطبقة المتعلمة أو المرفهة فقط. وهو تصور يعزز التفاوت الاجتماعي، حتى لو لم يكن معلنا.
وبعد الجدل الذي أثارته الصورة، أجرت إحدى الصحف المستقلة استطلاعا محدودا للرأي. أظهر الاستطلاع أن 62 في المئة من المشاركين يرون أن "زيارة المتحف تتطلب مظهرا معينا"، و أن 38 في المئة يشعرون بالحرج إذا دخلوا مكانا ثقافيا بملابس ريفية. هذه الأرقام، رغم محدودية العينة، تكشف نظرة مترسخة تربط الاحترام بالمظهر، والوعي بالملبس، والتحضر بتقليد النموذج الغربي.
وفي بيان مقتضب ردت إدارة المتحف بقولها إن "المتحف مفتوح لجميع المصريين دون تمييز". لكن البيان تجاهل المعنى الأعمق الذي فجر النقاش. المشكلة ليست في منع أحد من الدخول. المشكلة في أن كثيرين يمنعون أنفسهم مسبقًا، خوفًا من نظرة المجتمع.
وهو شكل من أشكال التمييز الرمزي الذي يعمل بهدوء ويؤثر بشدة. لا يتوقف الأمر عند حدود الطبقة والهوية. فهناك جانب نفسي مهم لا يمكن تجاهله. كثير ممن انتقدوا الصورة ينتمون في الأصل إلى بيئات ريفية أو شعبية. وقد أشار خبراء علم النفس الاجتماعي إلى أن الفرد الذي يصعد اجتماعيًا يفضل عادة أن ينسى جذوره الأولى، ويميل إلى الهجوم عليها حتى يؤكد انفصاله عنها.
إنها محاولة لبناء صورة جديدة للذات عبر رفض الصورة القديمة. يشبه الأمر شخصا مزق صورة قديمة له لأنه لم يعد يريد تذكر ملامحه في تلك المرحلة. لذلك، عندما ظهر الرجل والمرأة في المتحف بزيهما الشعبي، رأى البعض في مظهرهما انعكاسا لصورة قديمة يحاولون محوها من ذاكرتهم. فكان الهجوم عليهم أقرب إلى تمرد داخلي على الماضي منه إلى نقد موضوعي.
ويوازي ذلك ظهور ما يمكن وصفه بـ"البرجوازية الثقافية". فهناك فئة جديدة من المجتمع تعتبر أي مظهر شعبي تهديدا لاحتكارها للذوق العام. هذه الفئة ترى في الملابس العصرية معيارا حضاريا، وتتجاهل حقيقة أن التحضر الحقيقي لا يرتبط بالملابس، بل بقدرة المجتمع على قبول الاختلاف واحترام التنوع.
حين ننظر إلى تجارب دول أخرى، يمكن أن نفهم حجم الخلل في علاقتنا نحن العرب مع تراثنا الشعبي. ففي اليابان مثلا، لا يثير ارتداء "الكيمونو" داخل المتاحف أو الأماكن الحديثة أي استغراب.
كبار السن يرتدونه في الشارع ومحطات المترو، والشباب يستخدمونه في المناسبات والزيارات الرسمية. وفي متحف طوكيو الوطني، الذي يعد أحد أكبر المتاحف في آسيا، يرتدي عدد من الزوار "الكيمونو"، وينظر إلى ذلك باعتباره تعبيرا عن اعتزاز بالهوية لا نكوصا عن العصر. اليابان نجحت في أن تبني حداثتها دون أن تمزق جذورها.
فالدولة التي تتصدر الابتكار التكنولوجي احتفظت في الوقت نفسه بنسيجها الثقافي، واعتبرت الأزياء التقليدية جزءا طبيعيا من الحياة اليومية، لا دليلا على التخلف.
أما في النرويج، فيحتل الزي التقليدي "بوناد" موقعا خاصا داخل الوعي الوطني. يرتديه الرجال والنساء في الأعياد والاحتفالات العائلية. ويظهر في المتاحف والمدارس والفعاليات العامة بلا أي استهجان.
بل إن بعض المدن تشهد منذ سنوات مبادرات تشجع على ارتداء "البوناد" في الحياة اليومية. وينظر إليه باعتباره رمزا للقدرة على الجمع بين الهوية والحداثة. هذه النماذج تكشف السؤال المؤلم: لماذا تتحول الأزياء التقليدية في المجتمعات العربية إلى رمز للجهل، بينما تصبح في مجتمعات أخرى علامة فخر واعتزاز؟
لماذا يبدو الريفي في مصر مطالبا بإخفاء هويته بمجرد أن يخرج من حدود قريته، بينما يحتفي الياباني أو النرويجي بزيه كجزء من حضوره الإنساني؟ الإجابة ليست بسيطة، لكنها ترتبط بتاريخ طويل من النظرة الدونية للذات، ومن السعي الدائم إلى محاكاة نموذج خارجي باعتباره معيار التقدم.
وهو ما جعل الكثيرين يرون في الملابس الشعبية عبئا ينبغي التخلص منه، لا ثروة ثقافية تستحق الصون. إذا أردنا الخروج من هذا المأزق، فلا بد من مصالحة حقيقية مع الذات الثقافية. فالملبس ليس مجرد قطعة قماش نرتديها.
إنه جزء من الهوية. الجلابية ليست ضد البدلة، والريف ليس ضد المدينة، بل هما تعبيران مختلفان عن حياة واحدة متعددة الطبقات. المشكلة ليست في اختيار الزي المناسب للمكان. في كل دول العالم هناك "ملاءمة للمناسبة"، وهو أمر طبيعي.
لكن المشكلة تظهر حين تتحول "الملاءمة" إلى "تحقير"، وحين يصبح الزي الشعبي رمزا للجهل بدلا من أن يكون جزءا من تنوع المجتمع. في دار الأوبرا مثلا، ارتداء زي رسمي مفهوم باعتباره عرفا ثقافيا.
وفي الفرح الريفي، حضور ضيوف بجلابيب أمر طبيعي. لكن في مصر، أصبح الاختلاف نفسه يقرأ باعتباره تهديدا.
وأصبح كثيرون يشعرون بأن عليهم الاندماج في رغبات الطبقة المهيمنة كي ينالوا احترام المجتمع. هذا الخلط أدى إلى ما يشبه "القمع الاجتماعي غير المرئي". فحتى من دون قوانين رسمية، يمارس المجتمع ضغوطا هائلة على أفراده ليتبنوا مظهرا واحدا.
وقد حذرت تقارير صادرة عن "المنظمة العربية للتنمية الثقافية" عام 2022 من أن تنميط الذوق العام على نموذج واحد "يخلق فقرا ثقافيا يبتلع الفروق الطبيعية بين الفئات الاجتماعية".
ولم تستخدم الحداثة كسيف يقطع ما قبلها، بل كجسر يصل الماضي بالحاضر.
إن المصالحة مع الجلابية، بهذه المعاني، ليست مسألة لباس، بل خطوة نحو احترام الذات. فإذا استطاع الفلاح أن يدخل المتحف بثيابه دون أن يشعر بالحرج، فهذه علامة على أننا بدأنا نضع أقدامنا على طريق العدالة الثقافية.
لكي تتحقق هذه المصالحة، لا بد من تدخل واع من الدولة والمؤسسات الثقافية. المطلوب ليس تحويل الزي الشعبي إلى فلكلور جامد، بل دمجه في الحياة العامة باعتباره جزءا حيا من الهوية.
أولا: إدماج التراث الحي في التعليم ينبغي أن تعيد المناهج المدرسية تقديم الزي التقليدي باعتباره صفحة من الهوية، لا مجرد مشهد فولكلوري.
يمكن للطلاب أن يتعرفوا على تاريخ الجلابية والعباءة والقفطان والطربوش، وكيف تطور كل منها في سياق اجتماعي وسياسي. فالفهم الحقيقي يبدد السخرية، ويمنح الفرد مساحة لتقبل ذاته.
ثانيا: تفعيل المتاحف كمساحات للتفاعل يمكن أن تتحول قاعات المتاحف إلى فضاء يستضيف الحرفيين والمزارعين وأصحاب التراث الحي. هذا يجسر المسافة بين الماضي المعروض في "فاترينة" والماضي الذي ما زال يمشي في الأسواق والمزارع. وتوجد تجارب مشابهة في متاحف المغرب وتونس، حيث تعرض الحرف التقليدية بجانب القطع الأثرية، ما يكسر الحاجز بين النخبة والعامة.
ثالثا: إصلاح الخطاب الإعلامي الإعلام المصري، سواء في الدراما أو الإعلانات، يعيد إنتاج صورة نمطية للزي الشعبي. بينما المطلوب أن يظهر الريفي أو الصعيدي أو النوبي في أدوار القوة والنبوغ والنجاح، لا في موقع الشفقة أو الهامش. وقد نجح فيلم "الكيت كات" للمخرج داود عبد السيد (1991) في تقديم الطبقة الشعبية بصدق شديد، دون أن يحول الزي الشعبي إلى أداة للسخرية.
رابعا: تشجيع الإنتاج الفني غير النمطي يمكن لصندوق التنمية الثقافية و وزارة الثقافة دعم أعمال فنية تعيد الاعتبار للأزياء المحلية. ليس كعرض استعراضي، بل كرمز للقوة والوعي. فالثقافة لا تفرض من أعلى، لكنها تحتاج إلى نماذج تعيد تعريف العلاقة بين الماضي والحاضر. الصورة التي شغلت الرأي العام لم تكن مجرد مشهد عابر داخل المتحف الكبير. كانت مرآة كشفت أزمة طويلة عمرها عقود.
أزمة تتعلق بالهوية والطبقة والنظرة إلى التراث. وفي الوقت نفسه، كانت لحظة تستحق التوقف. لأنها أظهرت لنا الجرح الذي حاول المجتمع إخفاءه طويلا. لكن الجروح ليست دائما علامة ضعف.
أحيانا تكون بداية للشفاء. وربما تكون هذه الصورة، بكل ما أثارته من جدل، فرصة لنعيد ترتيب علاقتنا بأنفسنا وبتراثنا وببعضنا البعض. وأن نفهم أن التحضر الحقيقي لا يقاس بالملابس ولا بالماركات، بل بالقدرة على احترام الاختلاف واحتواء التنوع.
وحين يستطيع المصري ـ أيا كان أصله أو لباسه ـ أن يدخل المتحف أو الجامعة أو أي مؤسسة عامة دون خوف من نظرة الآخرين، عندها فقط نكون قد بدأنا أولى خطوات التحضر الحقيقي.








.png)